المحاضرة الرابعة
قراءة في معلقة زهير
نبذة عن الشاعر: هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة المزني، تربى ونشأ في كنف
أخواله فقد تكفل خاله بشامة بن الغدير بتربيته، وكان بشامة شاعرا جيد الشعر كما
كان شريفا ماجدا حازما كثير المال، يروى أنه لما حضرته الوفاة أوصى بجزء من تركته
لزهير وقال له: لقد أورثتك ما هو خير من المال؛ أورثتك شعري، والحقيقة لقد ورث
زهير منه الشعر والمال والخلق الكريم، وقد عاش زهير خلال الحروب التي نشأت بين
قبيلتي عبس وذبيان، وصَلِيَ الشاعر مع أخواله الذبيانيين بنار الحرب التي أتت على
الأخضر واليابس، ولذلك نشأ على بغضه للحرب ونفوره منها، وهو ما انعكس على شعره
الذي اتسم بالحكمة والدعوة إلى العيش في سلام ونَبْذِ الحروب، ومدح كثيرا (الحارث
بن عوف) و(هرم بن سنان) اللذين كان لهما دور كبير في إنهاء هذه الحرب، وتحملا دفع
ديات القتلى وحدهما، وهو بلا شك عمل عظيم يدل على رجاحة عقليهما وحبهما للسلام في
ذلك العصر الذي سادت فيه الحروب وخضع لمنطق القوة والاعتداء، وصف الأصمعي الشاعر
فقال: يكفيك من الشعراء أربعة؛ زهير إذا طرب، والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا غضب،
وعنترة إذا كلب. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سئل عن أشعر الشعراء قال: هو
زهير بن أبي سلمى؛ لأنه كان لا يعاظل في الكلام، ولا يتبع حوشي المعنى، ولا يمدح
الرجل إلا بما فيه. (انظر: جمهرة أشعار العرب وتاريخ الأدب العربي للدكتور شوقي
ضيف)
وقد
جاء في البيان والتبيين للجاحظ: أن زهير بن أبي سلمى كان يسمي كبار قصائده
الحوليات، ولعل هذا هو السبب في وصفه بأنه من عبيد الشعر، حيث قال الأصمعي: زهير
بن أبي سلمى، والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر، وكذلك كل من جوّد في جميع شعره، ووقف
عند كل بيت قاله، وأعاد فيه النظر حتى تخرج أبيات القصيدة كلها مستوية في
الجودة.
مات زهير قبيل دعوة النبي صلى الله عليه
وسلم بأعوام قليلة، ويقال إنه كان من المؤمنين بالبعث وكان يتعفّف في شعره، وفي
شعره ما يدلّ على إيمانه بالبعث، وذلك قوله:
(يؤخّر فيوضع في كتاب فيدّخر
** ليوم الحساب أو يعجّل فينقم)
أما عن شعره ومكانته بين شعراء الجاهلية، فقد
أجمع النقاد والباحثون على أنه لم يُعرف شاعرٌ اعتنى بشعره كما هو الحال مع زهير،
حيث تفرغ أو كاد للشعر منذ صغره، فكان راوية لزوج أمه أوس بن حجر، وخاله بشامة بن
الغدير، والشاعر المعروف طفيل الغنوي، فاصطبغ شعره وتأثر بطريقتهم في الشعر
وبالموضوعات التي كتبوا عنها، وقد تأثر بالشاعر ابنُه كعب والشاعرُ المعروفُ
الحطيئة، ولعل أكثر ما تميز به الشاعر وصُبِغ به شعرُه، هو ميله إلى الحكمة ومَدْح
عدد من سادة العرب وأشرافها، الذين اشتهروا بالكرم والمروءة وإسداء المعروف والإصلاح
بين الناس. وتُمثِّل هذه المعلقةُ خصائصَ شعره التي أشرنا إليها، وقد اخترنا بعض
أبياتها ويمكن الرجوع إلى دراسة مفصلة كتبناها في كتاب: من قضايا الشعر الجاهلي.
(مختارات من معلقة زهير)
فأقسمتُ بالبيت الذي طاف حوله
** رجالٌ بنوه من قريش وجرهم
يقول: حلفت بالكعبة التي طاف
حولها من بناها من القبيلتين. جرهم: قبيلة قديمة تزوج فيهم إسماعيل، عليه السلام،
فغلبوا على الكعبة والحرم بعد وفاته عليه السلام، وضعف أمر أولاده، ثم استولى
عليها بعد جرهم خزاعة إلى أن عادت إلى قريش، وقريش: اسم لولد النضر بن كنانة.
يمينا لنعم السيدان
وُجِدْتُما ** على كل حال من سَحيل ومُبْرَم
السحيل: المفتول على قوة
واحدة. المبرم: المفتول على قوتين أو أكثر، ثم يستعار السحيل للضعيف والمبرم
للقوي. يقول: حلفت يمينًا، أنكما نعم السيدان، وجدتما على كل حال ضعيفة وحال قوية،
لقد وجدتما كاملين مستوفيين لخلال الشرف في حال يحتاج فيها إلى ممارسة الشدائد
وحال يفتقر فيها إلى معاناة النوائب، وأراد بالسيدين: هرم بن سنان والحارث بن عوف،
مدحهما لإتمامهما الصلح بين عبس وذبيان وتحملهما أعباء ديات القتلى.
تداركتما عبسا وذبيان بعد ما
** تفانوا ودقوا بينهم عطر مَنْشَم
أي نعم السيدان وجدتما حيث
تداركتما أمر هذين الحيين بعدما تفانوا في الحرب، فأصلحتم بينهما، ومنشم: اسم
امرأة عطارة من خزاعة، كانوا إذا حاربوا يشترون منها الحنوط والكافور لموتاهم
فتشاءموا بها، ويقال: إن قوما تحالفوا، فأدخلوا أيديهم في عطرها، ليتحرموا به، ثم
خرجوا إلى الحرب، فقتلوا جميعا فتشاءمت العرب بها. والمعنى: تلافيتما أمر هاتين
القبيلتين بعدما أفنى القتال رجالهما وبعد دقهم عطر هذه المرأة أي بعد إتيان
القتال على آخرهم كما أتى على آخر المتعطرين بعطر منشم.
وقد قلتما: إن نُدركِ السلمَ
واسعا ** بمال ومعروف من القول نَسْلم
والسلم: الصلح، يقول: وقد
قلتما: إن أدركنا الصلح واسعًا، أي إن اتفق لنا إتمام الصلح بين القبيلتين ببذل
المال وإسداء معروف من الخير سلمنا من تفاني العشائر.
فأَصْبَحْتُمَا منها عَلَى
خَيرِ مَوْطِنٍ ** بَعيدَينِ فيها مِنْ عُقُوقٍ وَمَأثَمِ
العقوق: العصيان، والمأثم:
الإثم، يقول: فأصبحتما على خير موطن من الصلح بعيدين في إتمامه من عقوق الأقارب
والإثم بقطيعة الرحم، والمعنى: إنكما حرصتما على إبرام الصلح بين العشائر ببذل كل
غال ونفيس، وظفرتما به وتجنبتما قطيعة الرحم، والضمير في منها يعود إلى السلم.
فَأَصْبَحَ يَجْري فيهمُ مِنْ
تِلادِكُمْ ** مَغَانِمُ شَتّى مِنْ إفالٍ مُزَنَّمِ
التلاد والتليد: المال القديم
الموروث، والمغانم: جمع مغنم وهو الغنيمة، وشتى أي: متفرقة، والإفال: جمع أفيل وهو
الصغير السن من الإبل، والمزنَّم: المعلم بزنمة، يقول: فأصبح يجري في أولياء
المقتولين من نفائس أموالكم القديمة الموروثة، غنائم متفرقة من إبل وصغار معلمة.
ألا أبلغ الأحلافَ عني رسالة
** وذبيان هل أقسمتمُ كل مُقْسَم
الأحلاف والحلفاء: الجيران
والمفرد حليف، ومعنى: هل أقسمتم كل مقسم: أي قد أقسمتم كل أقسام. والمعنى: أبلغ
ذبيان وحلفاءها وقل لهم: قد حلفتم على إبرام الصلح كل حلف فتحرجوا من الحنث
وتجنبوا.
فلا تَكْتُمُنَّ الله ما في
نفوسكم ** ليخفى، ومهما يُكتمِ اللهُ يعلم
يقول: لا تخفوا من الله ما
تضمرون من الغدر ونقض العهد ليخفى على الله، ومهما يكتم من شيء يعلمه الله، يريد
أن الله عالم بالخفيات والسرائر ولا يخفى عليه شيء من ضمائر العباد، فلا تضمروا
الغدر ونقض العهد فإنكم إن أضمرتموه علمه الله؛ وقوله: يكتم الله، أي يكتم من
الله.
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر **
ليوم الحساب أو يعجل فيُنْقِم
أي يؤخر عقابه ويرقم في كتاب،
فيدخر ليوم الحساب أو يعجل العقاب في الدنيا قبل المصير إلى الآخرة فينتقم من
صاحبه، يريد لا نجاة من عقاب الذنب آجلا أو عاجلًا.
وَمَا الْحَرْبُ إلّا مَا
علمتمْ وَذُقتُمُ ** وَما هوَ عَنها بالْحَديثِ الْمُرَجَّمِ
الحديث الْمُرجَّم: الذي يرجم
فيه بالظنون أي يحكم فيه بظنونها. يقول: ليست الحرب إلا ما جربتموها وذقتموها
ورأيتم كراهتها، وما حديثي هذا بحديث ظن عن الحرب، بل حديث يقين شهدت عليه الشواهد
الصادقة من التجارب وليس من أحكام الظنون، فإياكم أن تعودوا إلى مثلها.
مَتى تَبْعَثُوها تَبْعَثُوها
ذَميمَةٌ ** وتَضْرَ إذا ضَرّيْتُمُوها فتَضْرَمِ
متى: شرطية، وتبعثوها:
تعيدوها وتشعلوها، وذميمة: قبيحة مذمومة، وتضرى: تشتعل وتلتهب، يقول: متى تشعلوا
الحرب تعيدوها مذمومة وتذموا على إثارتها، ويشتد لهيبها واشتعالها إذا أوقدتم
نيران الفتن بينكم من جديد فتلهبكم نيرانها، والمعنى: إنكم إذا أوقدتم نار الحرب
ذُممتم، ومتى أثرتموها ثارت ومتى هيجتموها هاجت، وهو يحثّهم على التمسك بالصلح،
ويعلمهم سوء عاقبة إيقاد نار الحرب.
فَتَعْرَكُكُم عرْكَ الرَّحى
بثِفالها ** وَتَلْقَحْ كِشافًا ثُمّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ
عركتهم الحرب: دارت عليهم،
وثفال الرحى: خرقة أو جلدة تبسط تحتها ليقع عليه الطحين، والباء في قوله بثفالها
بمعنى مع، والرحى: أداة يطحن بها، واللقح واللقاح: حمل الولد، يقال: لقحت الناقة،
والكشاف: أن تلقح النعجة في السنة مرتين، ويقال: أنتجت الناقة: إذا ولدت أو كانت
على أهبة الوضع، وتتئم أي تأتي بتوأمين، والمعنى: إنكم إن تبعثوا الحرب تطحنكم طحن
الرحى للحَبَّ مع ثفاله، ثم بالغ فقال: وتلقح الحرب في السنة مرتين وتلد توأمين،
وهذه مبالغة من الشاعر ليصف إفناء الحرب إياهم كما تفعل الرحى بالحب، وشبه الشر
الذي يتولد من تلك الحروب بالناقة التي تحمل بالتوائم.
فَتُنْتِج لَكُمْ غلْمانَ
أشأمَ كلّهمْ ** كَأَحْمَرِ عادٍ ثُمّ تُرضِع فَتَفْطِمِ
الشؤم: ضد اليُمن، والأشأم:
أفعل من الشؤم وهو مبالغة المشئوم، وكذلك الأيمن مبالغة الميمون وجمعه الأشائم،
وأراد بأحمر عاد أحمر ثمود وهو عاقر الناقة، واسمه قدار بن سالف، والمعنى: فتولد
لكم أبناء في أثناء تلك الحروب، كل واحد منهم يضاهي في الشؤم عاقر الناقة، ثم
ترضعهم الحروب وتفطمهم، أي تكون ولادتهم ونشوؤهم في الحروب فيصبحون مشائيم على
آبائهم.
فَتُغْلِل لكم مَا لا تُغِلّ
لأَهْلِها ** قُرىً بالعراقِ من قَفِيزٍ وَدِرْهَمِ
أغلت الأرض إذا كانت لها غلة،
وهو يتهكم ويهزأ بهم، والقفيز: المكيال والأرض الواسعة، والمعنى: أن الحروب تغل
لكم ضروبًا من الغلات لا تكون تلك الغلات كتلك التي تكون لقرى من العراق، كما أن
المضار المتولدة من هذه الحروب تزيد على المنافع المتولدة من هذه القرى، وهذا كله
حث منه لهم على الاعتصام والتمسك بالصلح، وزجر لهم عن الغدر وإيقاد نار الحروب،
وقيل: لا يأتيكم من الحرب ما تُسَرُّون به مثل ما يأتي أهل العراق من الطعام
والدراهم، ولكن يأتيكم بسبب الحرب ما تكرهون، فتُقْتَلون وتُحمل إليكم ديات قومكم
فافرحوا فهذه لكم غلة.
سَئِمْتُ تَكَاليفَ الْحَياةِ
وَمَنْ يعشْ ** ثَمَانِينَ حَوْلًا لَا أَبا لَكَ يَسْأَمِ
سئمت الشيء سآمة: مللته.
التكاليف: المشاق والشدائد، ولا أبا لك: كلمة تقال في المدح والذم وتقال للتنبيه
أيضا، يقول: مللت مشاق الحياة وشدائدها، ومن عاش ثمانين سنة ملَّ الكبر لا محالة.
وَأَعْلَمُ مَا فِي اليوْمِ
والأمسِ قَبْلَهُ ** وَلَكِنَّنِي عَنْ عِلْمِ مَا فِي غَدٍ عَمِي
يقول: وقد يحيط علمي بما مضى
وما حضر، ولكني عميُّ القلب عن الإحاطة بما هو منتظر متوقع.
رَأَيْتُ الْمَنايا خَبطَ
عشواءَ من تُصب ** تُمِتْهُ وَمَنْ تُخطئ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
الخبط: الضرب باليد،
والعشواء: تأنيث الأعشى، وجمعها عُشْو، والعشواء: الناقة التي لا تبصر ليلًا،
ويقال في المثل: هو خابط خبط عشواء، أي قد ركب رأسه في الضلالة كالناقة التي لا
تبصر ليلًا فتخبط بيديها على عمى، فربما تردَّت في مهواة وربما وطئت سبعًا أو حية
أو غير ذلك. قوله: ومن تخطئ أي ومن تخطئه، فحذف المفعول، والتعمير: تطويل العمر،
يقول: رأيت المنايا تصيب الناس على غير نسق وترتيب وبصيرة، كما أن هذه الناقة تطأ
على غير بصيرة، ثم قال: من أصابته المنايا أهلكته ومن أخطأته أبقته فبلغ الهرم.
وَمَنْ لَمْ يُصانعْ فِي
أُمُورٍ كَثيرةٍ ** يُضَرَّسْ بأنْيابٍ ويُوطَأ بِمَنْسِمِ
يقول: ومن لم يصانع الناس ولم
يدارهم في كثير من الأمور قهروه وغلبوه وأذلوه وربما قتلوه، كالذي يضرس بالناب
ويوطأ بالمنسم، والضرس: العض على الشيء بالضرس، والتضريس مبالغة. المنسم للبعير:
بمنزلة السنبك للفرس وهو طرف الحافر، والجمع المناسم.
وَمَنْ
يجعلِ المعرُوفَ من دونِ عِرْضِهِ ** يَفِرْهُ وَمَنْ لا يَتَّقِ الشّتمَ يُشْتَمِ
يقول: ومن جعل معروفه وقاية
لعرضه، وجعل إحسانه حماية لسمعته وَفَرَ مكارمه وصانها، ومن لا يتق شتم الناس إياه
شُتِم؛ يريد: أن من بذل معروفه صان عرضه، ومن بخل بمعروفه عرَّض عرضه للذم والشتم،
يقال: وفَرت الشيء أفِره وفرًا: أكثرته.
وَمَنْ يَكُ ذَا فَضْلٍ
فَيَبْخَلْ بفضْلِهِ ** على قَوْمِهِ يُسْتَغنَ عنهُ وَيُذْمَمِ
يقول: من كان ذا فضل ومال
فبخل به استُغنِي عنه وذمه الناس، ويذمم هي في الأصل يُذَمُّ.
وَمَن يُوفِ لا يُذَمَم،
وَمَن يُهْدَ قلبُه ** إلى مُطمَئِنّ البِرّ لا يَتَجَمْجَمِ
وفيت بالعهد أفي به وفاء
وأوفيت به إيفاء هما لغتان جيدتان؛ ويقال: هديته الطريق وهديته إلى الطريق وهديته
للطريق. والمعنى: إن من أوفى بعهده لم يلحقه ذم ولا عابه الناس، ومن هُدِي قلبه
إلى بر يطمئن القلب إلى حسنه ويسكن إلى فعله، لم يتردد ولم يتلكأ في إسدائه
وإيلائه وصنيعه.
وَمَنْ
هَابَ أسبابَ الْمَنايا يَنَلْنَهُ ** وإنْ يَرْقَ أَسبابَ السَّماءِ بِسُلَّمِ
رقي في السلم يرقى رقيًّا:
صعد فيه، ويروى ولو رام أسباب السماء، يقول: ومن خاف وهاب أسباب المنايا نالته،
ولم يُجْدِ عليه خوفه وهيبته إياها نفعًا ولو رام الصعود إلى السماء فرارًا منها،
وهو تعبير عن عجز الإنسان وضعفه أمام الموت وأن الموت مدركه لا محالة.
وَمَن يجعَلِ الْمَعرُوفَ فِي
غَيرِ أهلِهِ ** يَكُنْ حَمْدُهُ ذَمًّا علَيْهِ وَيَنْدَمِ
يقول: ومن وضع أياديه في غير
من استحقها، أي من أحسن إلى من لم يكن أهلًا للإحسان إليه والامتنان عليه، ذمَّه
الذي أُحسن إليه ولم يحمده، وندم المحسن الواضع إحسانه في غير موضعه، وهي حكمة
بليغة ونجد صداها في المثل القائل: اتق شر من أحسنت إليه.
وَمَن يَعْصِ أطرَافَ
الزِّجاجِ فَإِنَّهُ ** يُطيعُ العَوَالي رُكّبَتْ كلَّ لَهْذَمِ
الزِّجاج بكسر الزاي: جمع
زُجّ، وزج الرمح: هو الحديد المركب في أسفله، واللهذم: السنان الطويل، وعالية
الرمح ضد سافتله، والجمع العوالي، يقول: ومن عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح
التي ركّبت فيها الأسنة الطوال؛ والمعنى: أن من أبى الصلح ذللته الحرب وليَّنته،
لأن العرب كانوا يشيرون بزجاج الرمح إشارة إلى رغبتهم في الصلح، فإن أرادوا الحرب
أشاروا بالعوالي وبأسنة الرماح.
وَمَنْ لَمْ يَذُدْ عَنْ
حَوْضِهِ بِسِلاحِهِ ** يُهَدَّم وَمَن لا يظلِمِ النّاسَ يُظْلَمِ
الذود: الكفُّ والرَّدع
والحماية، يقول: ومن لا يكفّ أعداءه عن حوضه بسلاحه هُدِم حوضُه، ومن كف عن ظلم
الناس ظلمه الناس، يعني: أن من لم يَحْمِ حريمه استبيح، واستعار الحوض للحريم. قال
الأصمعي: ومن ملأ حوضه ثم لم يمنع منه غشي، وهدم. وهو تمثيل: أي من لان للناس
ظلموه، واستضاموه.
وَمَن يغترِبْ يَحْسِبْ
عدُوًّا صَديقَهُ ** وَمَنْ لَمْ يُكَرِّمْ نَفْسَهُ لَمْ يكرَّمِ
يقول: من سافر واغترب حسب
الأعداء أصدقاء؛ لأنه لم يجربهم فتوقفه التجارب على ضمائر صدورهم، ومن لم يكرم
نفسه بتجنب الدنايا لم يكرمه الناس.
وَمَهْمَا تكنْ عند امْرِئٍ
من خَلِيقَةٍ ** وَإِنْ خَالها تَخْفَى على النَّاسِ تُعْلَمِ
يقول: ومهما كان للإنسان من
خُلُق فظن أنه يخفى على الناس عُلم وكُشف ولم يَخْفَ عليهم، والخلق والخليقة واحد،
والجمع الأخلاق والخلائق، والمعنى: أن الأخلاق لا تخفى وأن التخلّق لا يبقى ولا
يستمر لأنه ليس الطبع كالتطبع.
وكائنْ تَرَى مِنْ صَامِتٍ
لَكَ مُعْجِبٍ ** زِيَادَتُهُ أَوْ نَقْصُهُ فِي التَّكَلُّمِ.
في كائن ثلاث لغات، كأيِّن
وكائن وكأي، والصامت: الساكت، يقول: وكم صامت يعجبك صمته فتستحسنه، وإنما تظهر زيادته
على غيره ونقصانه عن غيره عند تكلمه.
لسانُ الفتى نصْفٌ وَنِصْفٌ
فُؤادُهُ ** فَلَمْ يَبْقَ إلّا صُورَةُ اللَّحْمِ والدَّمِ
هذا كقول العرب: المرء
بأصغريه لسانه وجنانه.
وَإنّ سَفاهَ الشَّيخِ لا
حِلْمَ بَعْدَهُ ** وإنّ الفَتَى بَعدَ السّفَاهَةِ يَحْلُمِ
يقول: إذا كان الشيخ سفيهًا
لم يُرْجَ حِلْمه؛ لأنه لا حال بعد الشيب إلا الموت، والفتى وإن كان نزقًا سفيهًا
أكسبه شيبه حلمًا ووقارًا، ومثله قول صالح بن عبد القدوس:
(والشيخ لا يترك أخلاقه **
حتى يوارى في ثرى رمسه)
سَألْنا فَأَعْطَيْتُمْ
وَعُدْنا فَعُدْتُمُ ** وَمَن أكثرَ التسآلَ يوْمًا سَيُحْرَمِ
يقول: سألناكم رِفدكم
ومعروفكم فجدتم بهما، فعدنا إلى السؤال وعدتم إلى النوال، ومن أكثر السؤال حُرم
يومًا لا محالة، والتسآل: السؤال: وتفعال من أبنية المصادر.
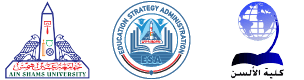 Faculty of Al-Alsun - AIN SHAMS UNIVERSITY
Faculty of Al-Alsun - AIN SHAMS UNIVERSITY